التكنولوجيا وأنا والسلّم
هل فكرتم بالجلوس تحت بريق النجوم أيها المتخمون من دخان العوادم ؟.. وهل جربتم أن تجدوا الحب في عيون جارتكم النائمة على الشرفة أيها المصدقون لأكاذيب الشات؟..
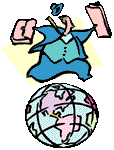
هل فكرتم يوما لما حظي مسلسل باب الحارة بكل هذه الجماهيرية وهل سألتم أنفسكم لمَ في الغرب ترتفع نسبة الانتحار ؟!..فهل هوالملل من العصرنة أم إنه الحنين إلى البساطة!.
لقد شهد العالم تطورا ملحوظا بالتطور التقني والتكنولوجي في القرن المنصرم وليتضاءل أمامها منجزات القرون الماضية حتى أنها لا تكاد ترنوفي مواجهتها.
دخلتْ التكنولوجيا على بيوتنا كأمر مفروض علينا وشيء لا بدّ منه ودخلناه كسجن بلا جدران، نحجز أنفسنا بتقنيات تريحنا عضليا وتتعبنا نفسيا وتسلب الكثير من واجباتنا الإنسانية الأخرى..
وقصتي مع التكنولوجيا قصة تبدأ بالتدرج فمشيت معها الهوينى ولم أركض بل سرت على أقل من مهلي.
وسأسرد لكم قصصي وقصص أهل حارتنا مع الحضارة وتقنياتها في رحلة جمعتْ سنين حياتي بين طياتها، وعساني أؤثر على جيل السرعة وأبطئ قليلا من ركضه المترنح.
المذياع :
منذ أن أبصرتْ عيناي الدنيا على وجه أمي وأبي، استمعتْ أذناي لصوت الأثير وأنا انظر لوالدي باستغراب وهو يدور إبرة الإذاعات يقلبُ من إذاعة إلى أخرى وكأنه يبحر برحلات ويطوف معه خيالي بقصصه فأبدو كمن يجلس في سفينة تشق عباب البحر ووالدي قبطانها يسيرها كما يرغب، عندما تعلو الموجة يغير مسارها وفي العواصف يوقفها في مكانها، وكنت أنا المسافر الصغير أشكو أحيانا من دوار البحر وتارة استمتع بصوته الذي يدغدغ أذني والنسيم اللطيف يحرك جفوني.
وكبرتُ ونما بالتزامن معي حبي للمذياع وبدأ خيالي يتوسع، فاسمع التمثيليات الإذاعية وأتخيل مجريات القصة وشخوصها، كما كنت اطمأن بنبرة المذيعين الهادئة وكم تخيلتُ مذيعات حسناوات من خلال صوتهن وتكسرت الصورة لدي بعد رؤيتهم على الشاشة الفضية.
وعشنا حالة الحرب مع صوت المراسلين وتخيلنا كيفية سقوط بغداد واستمعنا إلى مجريات الحرب عن طريق المذياع وعكس صوت المراسلين حالات الفرح والحزن..
وخاطبتُ بالمذياع شتى اللغات فتارة أكون بالمغرب وتارة بالهند وأحيانا انتقل إلى بلاط هارون الرشيد، وكلما استمع للمذياع أتذكر الشاعر المصري محمود غنيم وهويقول عن المذياع :
شاد ترنم لا طير ولا بشريا صاحب اللحن أين العود والوتر
التلفاز :

بعد مسيرات طويلة ونضال مستمر، قدمنا مطالبنا إلى والدي بشراء تلفاز ووافق والدي أخيرا مقابل هدنة متبادلة (شراء التلفاز = دراسة جيدة) وبسبب وضعنا المادي المتواضع كان بلونين أبيض وأسود، لنشاهد فيه أشخاصا يتحركون في حيز لا يتجاوز 14 بوصة دون أن يخرجوا من حدودها ولنستمتع بالظلال البيضاء والسوداء.
كنا نتابع البرامج المحلية والإرسال لا يكاد يتجاوز ال14 ساعة، كنا نجتمع سوية لمتابعة مسلسل السهرة ويلتم شمل العائلة حول هذا الساحر العجيب وينقطع الإرسال تارة ويتعطل التلفاز أحيانا فنبدأ بضربه حتى ترجع الصورة أويعود الصوت.
ثم دخل بيتنا زائر جديد هو التلفاز الملون لينزع من تلفازنا القديم رونقه ويحكم عليه بالإعدام وينكر فضله عليه لتحل مكان الظلال البيضاء والسوداء الألوان التي تعكس شخوصا يشبهوننا بأشكالهم.
السينما والفيديو:
كنت أنا وأخواي نذهب إلى السينما في أيام الأعياد والعطل نستطلع جميع دور السينما بالنظر إلى الصور المعلقة وبعد أن ننهك من البحث، ندخل إلى إحداها ونستمتع بالمشاركة الجماعية للفيلم –بغض النظر عن مستوى الفيلم –فالهدوء التام يطغى على الجمهور الذي ينفعل ويصفق بانفعال البطل وتدمع عيونهم بحزن البطل، وآه كم كنا نهتز مع الشاشة القماشية التي كانت تعكس آمالنا وأحلامنا.
ويراود مخيلتي مشهد لن أنساه مهما حييت كنت صغير السن، وكان الفيلم فيلما هنديا تاريخيا بجانبي شخص متلبك خائف حائر، وظهر مشهد أحصنة تقترب من الشاشة وكأنها ستصطدم بك فهرع هذا الشخص رافعا يديه للأعلى صارخا ((هووووووووووش))، وكأنه يحاول إيقاف الأحصنة.
فترة الاستراحة بين الفيلمين كانت 15دقيقة وكانت أفضل الفترات عندي لأسترجع أحداث الفيلم في مخيلتي مع أغان طربية جميلة إما لام كلثوم أوللعندليب الأسمر ..
دخل الفيديو إلى البيوت ليكون ابنا عاقا للسينما ففترت جماهيريتها، في حارتنا استقبل الفيديو بحرارة عالية واستغلها أصحاب المحلات في الدكاكين ليضعوا تلفازا وجهاز فيديو في الأعياد.
كنا ندخل إلى احد الأفلام غالبا أفلام كونغ فووكاراتيه مقابل مبلغ زهيد بالنسبة لنا نحن الأطفال كان مبلغا كبيرا نضطر لكسر مطمورتنا.
كنا نجلس مع أولاد الحي نتابع الفيلم بشغف وتضج الغرفة بالصراخ والتصفيق عند انتصار البطل ويسيل العرق على الجبين في المشاهد المشوقة وتخفي الأيدي الوجوه عند مشاهد القبل وكان أخي الأكبر يعصب عيني في مثل هذه المشاهد والمحظوظون من عندهم منديل مثقوب يخفي به وجهه..
في يوم الجمعة كنت اجتمع مع أولاد الحارة لنتجه إلى الجامع نصلي صلاة الجمعة سوية ونتناقش في خطبة الشيخ، ثم نذهب إلى الفوال لنأكل الفول المدمس ونستمع إلى صوت محمد عبد الوهاب في الراديو فتشعر كأنك جالس في مصر، وبعدها نذهب إلى المقهى لنحضر مباريات كرة القدم ونلبس قمصان الفريق الذي نشجعه ونستمتع بكؤوس الشاي اللذيذة التي لا يفارق طعمها فمي، ونرجع في المساء إلى بيوتنا إما الفرحة تغطي وجوهنا أو الوجوم يكسو وجوهنا..
الصحون الطائرة والكمبيوتر :
عندما غزت الصحون اللاقطة لتزين أسطح حارتنا خفتُ وخلتها غزوا من كوكب المريخ بالصحون الطائرة كما كنا نشاهد في برامج الأطفال.
واشترى والدي صحنا واللهفة تشدنا نحوه وسافرت كابن بطوطة أجوب العالم وأنا قابع على الكرسي لا أحتاج إلى بساط سندباد، فمن خلال جهاز التحكم أُقلب من محطة إلى أخرى وأتعرف على تجارب الشعوب وكانت تبدولي رحلة بالطائرة في إقلاعها خوف وتردد وفي هبوطها اطمئنان..
انمحت الحدود بين الدول وتحول العالم إلى قرية عالمية على حد قول مارشال مكلموهان عالم الاتصالات..
ومع الزمن بدأ الصحن اللاقط يفقدني برامجي المفضلة نتيجة تكرارها الممل وضجرت من بحثي الدائم عن الأفضل وبدأت لا أشاهد برنامجا كاملا.
شاهدنا ويلات الحروب بالصوت والصورة وتعرفنا على الراحلين بشكلهم الحقيقي، كما شاهدنا أيضا أنا وأهل حارتي تتويج ملكات الجمال وتوزيع جوائز الأوسكار و((الواوا بح )).
ثم دخل الكمبيوتر إلى المنازل الذي حوله الفارغون إلى مشغل فيديوأومسجلة للأغاني فقط.. وتبعها شبكات الانترنيت وأصبح بمقدورنا أن نحصل على ما نريد بدقائق صغيرة وجلّ ما أدهشني هونتاج كتاباتي التي سهرت عليها سنينا ونتاج مئات الكتب
تخزن على قرص مدور الشكل ولا يملأه كاملا، وتحولت مكتبات الكتب الجميلة التي كانت تزين الغرف إلى مكتبات ديفيدي وأصبح شرف الكتاب يباح على الأرض كأي صورة لنجوم الروك.
وأصبح بإمكاني أن أحصل على مراجع ومقالات وكتب ما كنت أحلم بها قط، كما حصلت على أغان لم أتوقع يوما أن اقتنيها ولكني بعد حصولي عليها تسرب الملل إلى نفسي وأصبحت أضجر منها، وتذكرتُ أيام كنت طالبا في المدرسة الثانوية بعيد الدوام كنت أتوجه إلى أحد المراكز لشراء شريط كاسيت وقبيل شرائه كنت أحلم به مرات عديدة وكيف سيكون وقع الأغنية على نفسي وعند شرائه وهوبين راحتي استمع إليه شفهيا ولا أملّ ولا أصدق أن اقطع مسافة ال6 كم بعد إفلاسي وأرجع للمنزل واستمع لألحانه التي لا أعجز منها أبدا..
ودخل الشات إلى بيوتنا وتحدثنا مع البعيد البعيد ونسينا القريب القريب، وتكلمنا مع من لا يحتاج إلينا ونسينا شخصا قريبا منا يحتاج إلى كلامنا الشيق ولترتسم ردود الأفعال على وجهه وتتغير نبرات صوته فنقرأ حاله النفسية ..
أصبح تبادل الرسائل الالكترونية واجبا علينا قبل أن نستمتع برسائل البريد التي تحمل رائحة الشخص بين طياتها وذوقه من خلال خطه ولنشاهد طابع البلد الذي يدل على حضارته..
درجات أخرى:
أصبحتْ أحاديثنا اليوم معظمها على الهاتف النقال، في حارتنا يوم دخل الجوال كنتُ أضحك طويلا عندما أجد شخصا يتكلم بالجوال فكان يبدولي شخصا مجنونا يتكلم مع نفسه..
فتحدثنا الكلام الكثير الكثير مع أناس بعاد وهناك أناس في الجوار ينتظرون منك كلمة..
أما من حيث وسائل النقل فكنا في القرية نتنقل على ظهر الحمار إلى كرم الزيتون، وكنت أتخيل نفسي فارسا على صهوة جواده رافعا رأسي عاليا فاستمتعت بسحر الطبيعة وجبالها وتنفست هواء القرية العليل، ثم اشترى والدي لي دراجة كنت أطير بها وأشعر أن العالم ملكي وأفرح عندما كان أصدقائي ينادونني بصديق البيئة..

كنتًُ أسافر في البداية بالباصات القديمة التي كنا ندعوها ((الهوب هوب )) فتجد فيها حديث ابن البلد وسذاجته وبساطته كما كانت الحميمية تطغى على الأجواء فأحدهم يتحدث عن الأمطار السنة والآخر يتحدث عن خدمة العلم والصعوبات التي واجهته والبطولات التي قام بها وكنا نجد أشجان كل شخص من رماد سيجارته أومن عيونه التي أذبلتها السنون..
وصعدتُ القطار القديم لأول مرة في الصف الأول، فكنا نطلق الضحكات مع صفارة انطلاقته ونختبئ في حضن والدينا حتى تجاوزه النفق، كنا نستمتع بالنظر إلى الطبيعة من خلال النوافذ المفتوحة والجبال العالية التي تخفي وراءها مستقبلنا والنسيم يتلاعب بشعرنا.
وجاء البولمان (الباص الحديث) وحمل معه برودة الأشخاص كل منهمك في نفسه وكأنه يحمل هموما تثقل الجبال وغاظني منظر النوافذ المغلقة فكم كنت أنظر إلى النوافذ على أنها غليظة القلب.
في إحدى القرى التي عُين أخي فيها لم تكن الكهرباء قد وجدت النور فيها كنت أرافق أخي، فكنا ندرس على ضوء مصباح النفط ونستمتع بهدوء الطبيعة، وفي أيام الغبطة نشعل الشموع وزفيف الرياح يلاعب النوافذ..
في حارتنا لحظة انقطاع الكهرباء كنا نطلع فوق السطح ونستمتع بجمال القمر ثم نعد عدد النجوم ونتأمل سيارات الطريق ليختار كل منا سيارته في المستقبل..
من ناحية القراءة بدأت بالقصص التي كان أبي يسردها لي وأغفوعلى صوته الذي يظل يداعب أذني حتى استسلم للنوم ثم اقتنيت القصص المصورة ومجلات الأطفال لأتعرف لأول مرة على الخير والشر والذئاب والأميرات وتابعت مشواري بالقصص البوليسية والألغاز التي كنت متشوقا لقراءتها لأبحث عن القاتل وأتخيل نفسي شارلك هولمز، ثم أسرد القصة لأصدقائي بعد إطفاء الأنوار وإشعال الشموع ليدب الرعب على المكان وأقصها عليهم بعد إضافة بهارات من عندي..
ثم اتجهت إلى الروايات لأتعرف على الحب وبعدها إلى الشعر لأجد كيفية كسر الكلام وكيف يفقد المعنى عذريته دون أن تعرف والده، وتابعت بكتب الفلسفة لأتعلم بأن اقرأ الصفحة الواحدة عشرات المرات دون أن افهمها ثم أعيد قراءتها لأفهم الجزء البسيط..
وكان حظي من الألعاب جيدا أيضا فقد جلب لي أبي دمية على شكل أرنب وسميتها وبدأت أتحدث معها وكنت كأني أربيها وأنا طفل مازال يحبو، ثم تعلمت لعب النرد وكنا نجتمع عند البقال لنحضر دوري النرد بين عجائز الحارة ذوي الخبرة، ثم أصبحت أتقن لعبة الشطرنج وتعلمت كيف حاصر نابليون المدن وأسقطها، ووتعلمت لعب الورق دون الإدمان وتعلمت على أساليب الاحتيال في اللعب، وكانت جميعها جلساتا حميمية من كان يخسر بيننا نحن الأطفال كان يعاقب بأن يغسل الصحون أويشاهد القناة المحلية في فترة الظهيرة، ثم دخلت ألعاب الكمبيوتر لتدخل الانعزالية ونجلس وحيدين أمام الحاسوب دون أن يحتك أحدنا بالآخر.
وأخيرا :
عزيزي القادم والحاضر لستُ بصدد أن أعرفك على ذكرياتي إنما نحن الآن بأمس الحاجة إلى التدرج في التكنولوجيا فهي سلالم علينا أن نخطوها خطوة خطوة، فمن يصل إلى أعلى السلم فورا نهايته القفز الإرادي إلى الأرض لا محالة.
هذه التكنولوجيا توفرت لنا نحن الجيل المحظوظ لنستفيد من كل خاصة فيها ونستثمرها فكل منها تملك خواصا تنفرد بها علينا اقتناصها، ودون التدرج سنشعر بالملل يتسرب إلى نفوسنا وستجد نفسك الهدف دون التكنولوجيا، وليكن استثمارها هوالهدف وليس العكس..
وطبعا التكنولوجيا وفرت لنا الكثير من الصعوبات وةدمت التسهيلات التي لا تحص كسهولة النشر والطبع والمراجع الوفيرة التي وهبتنا إياها حتى أننا لم نكن نحلم به حيث تستطيع أن تجد ماذا تريد ومن تريد.
ولكن تبقى مسألة الوعي هي الجوهرية أي أن يسير الوعي مع التكنولوجيا كخطي السكة الحديدية، وفي الصعوبة والبحث نجد متعة الحياة وفي البحث تكمن اللذة وكل شيء جاهز يبعث إلى الملل ويجعلنا إتكالين نعتمد على الآخرين في كل شيء ولعل أهم دليل على ذلك الدورات الخصوصية التي غزت البيوت منذ المرحلة الأولى، ولعل ما يخطر ببالي قول المخرج الفرنسي الشهير جان رينوار في كتابه حياتي وأفلامي:
((التقدم بالنسبة لي وهذا ما أعلنه وأعلنه الآن وسأظل أعلنه هوالعدوالحقيقي ليس بسبب أنه لا يسير بنجاح كما يشكوأنصار التقدم بل لأنه بالتحديد يسير قدما ليس لأن الطائرات تتعرض لبعض الحوادث بل لأنها تقلع وتهبط بموعدها المحدد ولأنها مريحة، فهذا التقدم يمتاز بالخطورة لأنه يعتمد على تكنولوجيا خالية من العيوب وكان من شأن نجاحه أن قلب قواعد حياتنا واجبر الإنسان على العيش ضمن أبعاد لم يخلق لأجلها هذا إذا ترك لنا ذلك العدوالوقت للتكيف معه ولكن لا نكاد نصل لنوع من الاستقرار حتى يظهر ابتكار جديد فيضع كل شيء موضع التساؤل))*
*جان رينوار حياتي وأفلامي ترجمة حسن عودة دمشق وزارة الثقافة المؤسسة العامة للسينما ص112-113.















