رائحة الوقت!
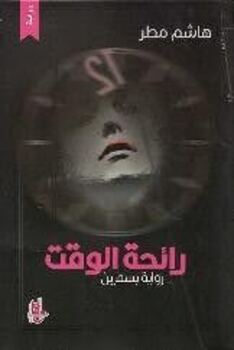
القسم الأول:
"رائحة الوقت" رواية تتميز ببنيةٍ سرديةٍ خاصةٍ، لكثرة أحداثها، وسعةِ حجمها وتعدد شخصياتها "الثانوية" وحكاياتها البطولية الطويلة، التي تتجمع حول البطلة المحورية مريم. ولا تختلف هذه الرواية كثيراً عن الروايات الإطارية ذات القصص "المعلبة"، نخرج من قصة لندخل في أخرى، مكرّسة لعدة مصائر بشرية متنوعة، ولهذا قد نجد أكثر من شخصية "محورية" لتعدد سردياتها!
إنها إپوپيّا زاخرة بموضوعاتها الكثيرة والمثيرة. وينبهر القارئ بمعلومات الكاتب الدقيقة، والوصف الصريح المفصل، لدرجة أنه يشعر أحيانًا بقشعريرة بدنه أثناء قراءته لهذه (الوثيقة) الأدبية، لبشاعة الجرائم المرتكبة ضد المدنيين. لكن قد يكون من المفيد التذكير هنا بضرورة اتسام شخصية مريم المحورية بالذات، بشغفٍ (بافَث) وحماسةٍ أكثر ديناميكيةً ووضوحاً، بحيث يمكن للقارئ لمسها من خلال أفعالها وليس كلامها، لا سيما وأنها "قيادية" تستلهمُ بطلة رواية "والفجر هادئ هنا" السوفييتية.
وهذه الرواية جهد سردي فني كبير، رغم الوصف (بالأسود والأبيض) بعض الأحيان، إذ إنّ المقاطع التحليلية والواقعية لها أهمية في البناء السردي، ولولا متعة القراءة والتشويق لما استطعت كقارئ إنهاءها.
ولهذا يسعدني أن أقدم هنا انطباعاتي الإيجابية عنها، رغم بعض الزيادات والاستفاضات السردية الكثيرة التي قد يكون من الأفضل اختصارها والاحتفاظ بها لنتاجات اخرى!
ولا شكّ أن الروائي هاشم مطر حرصَ على تدوين هذه التفاصيل الكثيرة عن أحداث التهجير الفظيعة بدافع الشعور بمسؤولية الكتابة كشاهد على الحقيقة، خوفاً من إغفال التاريخ لها أو "التاريخ غير المحايد" كما قال لي في حديث شخصي.
البنية والسرد:
عندما قرأت هذا العمل تذكرت رواية ميجيل آستوريس "السيد الرئيس" حيث نقرأ فيها قصصَ تحولات المكان والزمان وموضوعات كثيرة أخرى مثل حياة الناس في ظروف قاسية، وإلى حدّما "مئة عام من العزلة" لماركيز، وذكّرتني دمية شيرين ب "بائعة الخبز" للفرنسي كزافيه دي مونتابين، و"مذلون مهانون" لدوستوييفسكي، ولا أقصد هنا تأثر الكاتب بهذه الروايات بقدر الإشارة إلى تشابه "تايبولوجي" نمطي طفيف بسبب تشابه الظروف وحاجات البشر أينما وجدوا ما يؤكد إنسانية هذا العمل.
يقوم معمار هذه الرواية على فصول بلا عناوين مكرّسة لأغلب أبطالها، يلعب في سرديتها سارد عليم في وصف جريمة التهجير، خفّي، يقف وراء كل بطل يأتي السرد على ذكره فيطلع القارئ على حاضره وماضيه. وفي الحقيقة، إن هذا يتم بين فترة وأخرى من خلال ذكريات مريم بطلة الرواية المحورية. فكلما تظهر شخصية يكرس لها الكاتب حيّزاً غير معنون لسرديته، يحكي لنا "راوٍ خفيٍّ" حكايتَها عن مصيرها كأننا نقرأ حكايات ألف ليلة وليلة بالتدريج وبهدوء، وكأنها ذكريات شخصيات.
نلاحظ أن الكاتب لا يستخدم المونولوج التقليدي كثيراً، بل يلجأ أيضاً إلى حوار من المخيّلة بين البطلة وخطيبها سامر مثلاً، أو من خلال بنية سردية تعتمد على الفلاش باك وهجين من عناصر سرد وذكريات، وحوارات افتراضية.
أحداث الرواية:
أحداثٌ قاسيةٌ، جدا، وهناك أمور غير واضحة تماماً، رغبةً من الكاتب لإبقاء الغموض يحيط بالسرد والمضمون، ويقدم المعلومات تدريجياً، فهل مريم مثلاً صبية لم تكمل الثانوية لا تزال في سنة التخرج أم أنها أنهتها. ص 74 ومع ذلك يقرر أحد الآباء أن يبقي ابنه أمانةً في عنقها قبل أن يلقى حتفه ساقطاً في الوادي. في بعض المرات يصوّر الكاتب حدّة المواقف السياسية وذكريات الحب، فمثلا هم تحت سيطرة العسكريين، ومع ذلك تلاسنهم مريم، تقول "نعرف طريقنا جيدا لسنا بحاجة إلى نصائحك أيها العسكري". 72
من أجمل ما قرأتُ في "رائحة الوقت": الصفحات الأخيرة (كولمَنَيشِن) لنهاية السردية، لانسيابيتها وتدفّقها وانسجامها مع روح شخصية الأم! سرد رائع يصوّر بدايةً جديدةً، لبث الروح إلى الحياة من جديد، يتميز ببنيةٍ سردية حيوية، من خلال انتقالاته المكانية الزمانية وتقاطعاتها، بينما ابنتها (مريم) تتطلع من نافذتها المطلّة على بحيرة دنمركية إلى الفضاء وتفكّر بتأمّلات والدتِها ونظراتها إلى مرقد الإمام الرضا في مشهد وهي جالسة على كرسيها المتحرك فيتجسد تقاطع علاقات الأبطال الإنسانية!
هذا الجزء بحد ذاته يصلح ليكون قصةً طويلة واقعيةً پوفِست povest (بالروسية)! أو رواية قصيرة (نوفيلّا) حسب المفهوم النقدي الإنجليزي! العمل كلّه سردية ملحمية طويلة!
هناك قصص تميزت ببنية سردية رائعة مثل قصة شيرين، ونرجس وكمال، ووليد ونور، ومدى سعادة والدة مريم بعودة زوجها إليها وهي في معسكر اللاجئين على الحدود الإيرانية!
تستحق فعلاً القراءة والدراسة! من أروع ما قرأت في هذه الرواية الطويلة من تصوير واقعي وإنساني حيث يتغير مزاج والدة مريم بعودة زوجها رغم سكنهم في مكان خاص باللاجئين، لكن مع ذلك تدبُّ الحياة فيها، وتتغير تصرفاتها اليومية، ونظرتها إلى الحياة نحو الأفضل، ويتحوّل التشاؤم والإحباط إلى تفاؤل!
وتبتسم للحياة كأننا أمام رمز عميق لقدرة الحب على ردم المسافات وتحويل الأحزان إلى أفراح!
الأمر نفسه يمكن قوله عن نهاية الرواية التي تقررها الأم بنفسها، حيث تبدأ الحياة تدب أيضاً من جديد في عائلتها بتزويج ابنتها سهيله، وترمم منزلهم وتبتسم لها الدنيا بعودة ولدها وتزور الإمام الرضا، وتكون النهاية سعيدةً أليغوريةً (رمزية وعظيّة) بمسحةٍ معاصرةٍ بامتياز!
تتميز هذه الرواية بمعرفة عميقة بتفاصيل الأماكن في الوطن الأم الأول والثاني، مثل الأهوار والحدود العراقية مع إيران! وعناية فائقة بموضوعاتها، وتطرح فظاعات المجتمع العراقي والصراع بين المتنورين وقوى التخلف!
تتحول الصور إلى مآسٍ قاسية جدا يصعب تصورها، مثل قصة الجندي المنتفض "المنشق" سامر، لا بدّ أنها ستترك انطباعاً مؤثّراً وقوياً لدى المتلقي. وسيواصل السارد حكايتَه عن هذا البطل منذ بدء علاقته مع زميلته الجامعية وحبيبته سمر ليكشف عن تطورهما الملحمي، ويستمر السرد حتى يصل إلى قصة حياتهما وخلفيتهما السياسية ووقوف السلطة ضدَّهما حتى في خطبتهما.
الشخصيات:
يحكي السارد العليم قصصاً كثيرةً عن مجموعة كبيرة من المصائر الإنسانية، تتميز ببنية سردية متقنة، لولاها لأضحت مفكّكةً. ويستخدم الروائي هنا طريقةَ قدوم البطل من مكان إلى آخر. يدور الحديث هنا بالذات عن بطلة الرواية مريم، التي ستأخذ الحيز الأكبر في الحكايات، حيث كما يبدو أنها قادمة من إيران لتلتقي "بزوجها الدنمركي (كامل الأوصاف! ز. ش.)! وسنرى أن الأمور تتغير، حيث تشعر من خلال المكالمة الهاتفية أنه غير متحمس للقدوم إليها ولا مكترث بها، لكنه يتظاهر عكس ذلك! تلتقي بموظف استعلامات الفندق وليد، الذي يبدو من خلال أحاديثه أنه مضطهد من سلطة هذا البلد، وهناك إشارات في بداية السرد بأنه قد يكون من الكُرد الذين يعانون هنا من التمييز، ولهذا قد يكون هناك تعاطف داخلي فيما بينهما.
مستويات وأصوات سردية متنوعة:
نلاحظ هنا عدة أصوات سردية، الأول: السارد العليم، مخفيّ وراء البطل نفسه الذي يدور عنه القص، قد يكون راوياً أحياناً، و"صورة الكاتب" وصوته تارةً أخرى، وهجيناً عابراً لكل هذه المستويات. يحدث ذلك من خلال تناغم صوت البطل مع السارد أو "صوت الكاتب" فمثلاً عندما يكون السرد عن مريم، يختلط صوتها مع الكاتب أو سارده العليم (صوته)، الذي يتابع أيضاً حركةَ الأبطال، ويتحدث عن ورطة يقع فيها "زوجها" كامل في كوبنهاجن فيسبر أغواره من خلال سرد متعدد المستويات والنغمات أو (البوليفونيا). ص33 و 34- 35
فالسرد هنا لا يتخذ صيغة مونولوجية تقليدية تكشف عن عالم البطل مثلاً، ولا حكايات "راوٍ" واضحٍ جنباً إلى جنب مع الأبطال الآخرين كما هو الحال في العديد من السرديات، لكنه هنا خليط من تلك الأشكال التي أشرتُ لها: السارد العليم، صوت الكاتب وصورته وعناصر مونولوجية، فضلاً عن حوارات الشخصيات نفسها مستمدّة من الماضي والحاضر وأماكن مختلفة ضمن ذكرياتها، فيتجسد الهرونوتوب (الزمكان).
مريم:
يعطي السرد إحساساً بخصوصيّةِ مريم وسموّها وسِمتِها الأليغورية النسبية والعفوية غير التقليدية بدون تخطيط من الكاتب، حيث وضّحَ لي في حديث شخصي لي معه طريقةَ اختياره لأسماء شخصياته: "يمكن اعتبارها بين بين أو تلقائية، فقد وجدت (مريم) اسم مشترك إضافة الى سماحتها كصورة عفوية. كذلك (أمير) مسلم، مركب بين الأمير كنايةً عن رقيّه كإنسان ثم لقبه مسلم بقصد الانتماء. سمر وسامر مقصودان كتشابه وعموما لا اظن ذلك يعني الكثير. برغم تفكيري لإعطاء اسم مناسب لأية شخصية".
يشكّل سامر حقّاً رمزاً عميقاً قوياً متأصّلاً في الواقع السياسي والقيم العراقية الحقيقية الراسخة، بالذات كونه شاباً عراقياً غير مسلم كما سيعرف القارئ فيما بعد. لهذا يستشهد من أجل مساعدة المهجرين، ويتمكن من أن يدسّ بيد مريم بعض الأوراق والمعلومات التي عليها الاحتفاظ بها منادياً إيّاها "رفيقة" مريم. ويبدو أنهما على علاقة حزبية. ص 69
وتصبح هذه الأوراق (الأمانة) تتمةً ًللرمز الأليغوري وتأكيداً لأهميته بالنسبة للسرد، بحيث تحافظ مريم عليها حتى نهاية الرواية حيث تلتقي بخالته التي بكته في "مأمنهم العلماني" كوبنهاجن بعد أكثر من عقد من الزمان متقاطع مع مختلف الأزمنة والأماكن.
وهنا قد يتبادر إلى ذهن القارئ سؤال: كيف له أن يعرف أن مريم "رفيقة"، وكيف صادفت أن تكون الأوراق المهمّة التي أرادَها الاحتفاظ بها بحوزته أثناء الحدث، ممّا يجعله يشعر به كنوع من الإقحام، لكن مع ذلك كل شيء ممكن في المضامين والحبكات وعالم الصُدَف.
يتخيل سامر أن حبيبته "سمر تلفُّ كتفيه بذراعين نحيلين وتطبق شفتيها ... وتهمس له لا تتعجّل حبيبي بإطلاق النار على هؤلاء الأوغاد". دعته لجولة في إحدى الحدائق... المرطبات في "كيت كات" ... ويرد لها ... ثلاثية نجيب محفوظ... ... والمركز البريطاني .. سنغني معهم للشيخ إمام...". ص66
لكن مريم تتميز عن الأبطال الآخرين من خلال "استحواذها" على الذكريات، بحيث تكاد تكون الأقرب إلى صوت الكاتب. تتذكر مريم مثلاً صديقتها أحلام، فينساب السرد عن قصة حياتها وصديقها وعذاباتهما. ص 52-51
وكما ذكرتُ سابقاً في معرض حديثي عن بنية السرد، كل شخصية يأتي الكلام عنها بمن فيها بعض الشخصيات الثانوية، يصورها السارد، بل يتعمق أحياناً في وصفها، مثل سلوى الدنمركية العراقية المغتصبة من قبل زوج أمها، ويتناول الدنمركيين عن بُعد ولهذا غالباً ما يكون ذلك إيجاباً، ص41 فالكاتب لم يهمل أي شخصية يذكرها السرد.
وليد، موظف استعلامات الهوتيل، الذي أشرنا إليه، يُعينُ القارئ في فك لغز مريم، القادمة الجديدة على مسرح أحداث الرواية، يبدأ بالتساؤل عنها، من هي؟ يفهم أنها مهجّرة عراقية لا تجيد الإنجليزية ولا استخدام الموبايل، تعرّف إليها، وصار يلتقي بها في مقهى العندليب في قسم العوائل. ص 38
يصعب أحياناً على القارئ معرفة هوية الشخصيات بالضبط لكون لغة حواراتها لا تتم دوماً بلهجاتٍ واضحةٍ، بل "بالفصحى" تقريباً، نذكر على سبيل المثال لا الحصر، استخدام كلمة "تزجية" الوقت مثلاً بدلاً من "قضاء الوقت" في لغة الحوار.
يقدم السارد "الحاكي" سرديتَه تدريجيّاً، "مبرراً" مقدرة مريم وخبرتها في التعامل مع الحدث قائلاً "كانت مريم ... تكشف من سر ملاعب الأمس ما ينفع لليلةٍ كهذه". ص 74 ، والأمر نفسه تقوم به شقيقتها سهيلة التي ترشد الآخرين نحو الطرق الصحيحة.
وأثناء انتقالهم أو مسيرهم على حافة الحفرة والطرق الجبلية الضيقة، ظهر أبطال من الشباب الأقوياء مثل خالد الذي كان يشد بعض الحبال ليساعد الناس في المسير كيلا يسقطوا في الوادي، بينما كانت مريم تتذكر رواية "والفجر هادئ هنا" للكاتب الروسي السوفييتي بوريس فاسيلييف، وهي من أجمل روايات جيل ما بعد الحرب في الأدب السوفييتي لابتعادها عن المباشرة والتقليدية والخطابة السياسية والدعاية والوعظية التعليمية الساذجة، والخ من آفات بداية النثر الواقعي.
ألهمت هذه الرواية الكاتبَ وبطلتَه مريم التي تقرأها حتى وهي في غمرة الأحداث! القصة مترجمة من الروسية إلى العربية عام 1970 ولا بدّ أنها انتشرت في أوساط فئةٍ قراء عراقيين متميّزين آنئذ، معروفين بحماسهم.
وكان أيضا على أبطال "رائحة الوقت" أن يجتازوا ممراً خطيراً، يصعب تصور هذه المصاعب وهذه الأحداث، التي وصفها الكاتب بالتفصيل وصفاً دقيقاً.
وتظهر هنا شخصيات وأسماء كثيرة مثل جميل وكريم وخالد، وحتّى أولغا الروسية بطلة "والفجر هادئ هنا"، التي قد يصعب على القارئ العادي فهم ما يجري، هل هي (أولغا) معهم في الحدث أم مجرد إلهام.
يقول "بينما كانت مريم تحاول إخفاء ذعرها بجهد كبير، قفزت (اولغا) من الكتاب، ترافقها عودتها، "لا تقلقي سينتهي الأمر، بأقل خسائر، اقرأي بضعَ صفحاتٍ أخرى". ص 78 ثم قالت "الخوف ضروري يا مريم، إذا ما سيطرتِ عليه سيتحول إلى معين لك، في أحوالٍ كهذه". ص 78، بل إنها (مريم) تتحاور معها، " أغلقت الكتاب ... وشكرت أولغا. لكن أولغا لم تغادرها، فقالت: ستنجحين يا مريم". ص 81 أعتقد، قد يحتاج السرد إلى بعض التأني كيلا يبدو الإلهام والرمزية نوعاً من الإقحام.
توجّههم مريم وتقودهم أثناء الطريق "انتبهوا! صاحت مريم وهي تشرح خطة عبور المنطقة الضيقة لعدد من رفاقها". 78
وهنا قد يتساءل القارئ كيف عرفت مريم فجأةً وبدون أي تمهيد في القص هذا الطريق في "ديارهم" هناك كما يحلو لمريم أن تسمي الآن بلدها الأم، ولماذا تشرح لهم الخطّة ومن أين لها هذه الخبرة؟ ص 79
والجواب كما اعتقد أن مريم ليست مجرد شخصية عادية تماماً، بل هي أيضاً أليغورية تمثّلُ الخير، كما أشرتُ، وسنلاحظ ذلك في كلا "السفرين" سواءَ تقصّد الكاتب عمل ذلك أم لا، فهذه الفكرة هنا نتيجة لتحليل الرواية، ليس بالضرورة بتخطيط من الكاتب.
ورغم تهجير مريم قسراً من العراق، إلا أنها تعاني من النوستالجيا مجسّدةً ذلك في ذكرياتها عن بلدها العراق ومساءاته الشتوية و"مدافئ علاء الدين ومناقل شاي يتحلقون حولها ويأكلون "الكستناء الذي يبتر انفجارها قصصهم فيضحكون كأنهم ينتظرون تندرها". ص 81
وهناك قصة مؤلمة للغاية، يصف الكاتب فيها سقوط أم فاضل في الوادي، رغم استماتة جميل و"رفيقه" ومريم في إنقاذها. وصفٌ دقيقٌ لحدثٍ قاسٍ بحيث يتعاطف القارئ معهم، ويحتاج إلى مزيد من التركيز لفهم جسامة الحدث ووحشيته واستيعابه.
في كل هذه الأثناء تتحدث مريم عن المآسي وتقدّم نصائحَها، وهنا يتبادر أيضاً إلى الذهن التساؤل السابق عن سرِّ اكتساب خبرتها، وهي في مقتبل عمرها؟ فهي صبية، من أين لها هذه القدرة لتعطيهم هذه النصائح؟ لا بدّ أن يكون وراءها مغزى أدبي ألراد الكاتب أن تمثّله بوعيٍ منه أو بدونه. "وارتخت يدا جميل فلم تستطع أصابعه تحمّل ثقل ينجذب نحو الأسفل..." ص 81، "إنه القدر يا جميل، قالت مريم " علينا مساعدة الآخرين". ص 81 وهو ما يؤكد رمزية هذه البطلة الشابة، أو "أليغوريّتها"، التي اشرتُ إليها.
أغلقتْ الكتاب أمام عينيها وشكرت أولغا. لكن أولغا لم تغادرها، فقالت: ستنجحين يا مريم". ص 81
فكما يمكن ملاحظته أن مريم تتصرف كإنسانةٍ أكبر من عمرها، بل إنها مصدر إلهام مستوحى من شخصية أولغا بطلة قصة "والفجر هادئ هنا"، فهي هنا ليست رمزاً للأم، فحسب، بل أيضاً أليغوريا مريم العذراء!
أم فاضل التي سقطت هي والدة صديق جميل، الذي بذل قصارى جهده لإنقاذها، ومع ذلك يشعر (جميل) بالكاثارسيس أو جلد الذات لسقوطها، لكنه، في المقابل، أنقذ الطفل الصغير. نلاحظ هنا أيضا الإشارة إلى رواية "الأمير الصغير" لمؤلفها أنطوان دو سانت إكزوبيري" فهو يتذكرها أ أثناء عبورهم الممرات. ص83 وسنرى في هذه الرواية إشارات كثيرة للغاية إلى الفن والثقافة والشعر والأدب.
الزمان والمكان:
يذكرُ الروائي هاشم مطر الزمانَ والمكانَ بدون تحديد دقيق، بل يصفه بشكل عام، أو بتلميح: قبل أعوام كثيرة، أو في الخريف، في ص 22 وغالبا ما يشير في عمله هذا إلى الزمان بعبارة "تلك الأيام". ص 43
لا يتضح الزمان بشكل مباشر، بل من خلال إيحاءات بأن الأحداث تدور منذ بداية السبعينات حتى التسعينات، حيث يذكر أغاني الشيخ إمام، وفيروز المنتشرة آنئذ، و"الكيت كات"، والذكريات الجميلة، وينتقل إلى قساوتها فيصف التعذيب البشع أثناء ملاحقة اليساريين وإذلالهم بتلقينهم أفكار (الحزب والثورة) وإجبارهم على الانضمام إلى لجان" الصف الوطني" لغسل أدمغتهم، محققاً الهرونوتوب (الزمكان). ص 67
كل هذه الأحداث تُختصر بسرد يتضمن عناصر المونولوج وحوارات قديمة، وأخرى متخيّلة بينه وحبيبته، مستمدّة من ذاكرة البطل سامر مثلاً، أثناء خدمته كجندي ويده على زناد سلاحه! "تسلل الخدر إلى عروقه فأرخى إصبعه على زناد البندقية لكنه أبقاها موجّهة إلى صدور العسكريين". ص 67
ورغم أن هناك تلميحاً غير صريح عن الزمان، لكنه مع ذلك واضح للمطّلع على أحداث العراق المعاصرة، وبخاصة عندما يتكلم عن "الصف الوطني" والتسفير، والحرب القريبة، بالتأكيد انه يقصد الإيرانية العراقية 1980 ومعلوم أن التهجير الثاني حدث أيضا في العام نفسه. ويتضح الزمان من خلال ذكريات الشخصيات. وأشار الروائي أيضاً إلى أن التسفير بدأ بعد محاولة اغتيال مسؤول سياسي في الجامعة المستنصرية.
لكن هناك صعوبة في فهم تضاريس المنطقة الجبلية التي كان عليهم اجتيازها كونها واقعةً على الحدود مع إيران، حيث هناك حفرة كبيرة ظهرت صدفة، فأحياناً يشعر القارئ بصعوبة فهم التضاريس الحقيقية. ومع ذلك نلاحظ أن مريم تحتضن أخاها الأصغر رغم الصعوبات والهوة العميقة التي يمكن لأي شخص أن يسقط فيها، وهناك فعلا مَن سقط فيها، بحيث إن أحد الآباء تركَ ابنه أمانةًً عند مريم بالذات، لتحافظ عليه، مما يؤكد مغزى شخصيتها الفني.
ويشهد الفندق في العاصمة الغريبة بداية السرد وبطريقة قدوم البطل إلى بلد آخر. ص 17 وتتذكر مريم الماضي، تتصل ب "زوجها" كامل متذكرةً صورة اغتصابه لها في دخلته الأولى عليها. ص 22
يفهم القارئ أنها في بلد يسمح باستعمال الموبايل في تلك الفترة، على عكس العراق. فالمكان يبدو، في سوريا، والأجواء تشبهها، يذهبون إلى بائع العسل وهناك تلتقي بأمير الذي يمثل دور المهذب ويتحدث باللهجة السورية: سيدي يا سيدي! ص 26
نادراً ما يشير الكاتب إلى المكان بوضوح مثل: راس النبعة، لكنه مع ذلك غير معروف بالنسبة لمن لا يعرف هذه المنطقة هل هو في لبنان؟ أم سوريا؟ يذكره عند تزوير جواز سفر لأمير إسلام. أخيراً لا بدّ من القول إنها رواية مكرّسة لزمننا الشرقأوسطي الذي نشم رائحته فيها، تتميز بالحضور والغياب والرحيل، والصراع بين الأخيار والأشرار، تذكرنا برواية "شرق المتوسط" للراحل عبد الرحمن منيف!
*بوريس فاسيلييف 1924-2013: ينحدر فاسيلييف من عائلة نبيلة. تطوّع في الجيش السوفيتي سنة 1941 عند بلوغه ال 17 عاماً، كتبَ روايات قصيرة مثل "والفجر هادئ هنا" 1969 أولى روايات فاسيلييف الوطنية العاطفية عن بطولات النساء في الحرب العالمية الثانية و"غير مدرجة في القائمة النشطة" ١٩٧٤؛ و"غدًا تندلع الحرب" ١٩٨٤. ترجمت رواية "والفجر هادئ هنا" الى العربية سنة 1970 وصدرت ضمن سلسلة "مقاتلون في سبيل وطنهم السوفيتي" في الذكرى 25 للانتصار على الفاشية في الحرب العالمية الثانية. أكسبته شهرة واسعة في الاتحاد السوفيتي والصين ودول اشتراكية أخرى. وتصوّر بعض كتبه قسوة الحياة في روسيا الستالينية.
رواية فاسيلييف القصيرة "لا تطلقوا النار على البجع الأبيض" (1973)، التي تُعدّ علامة فارقة في أدب الخيال البيئي الروسي، تنتقد بشدة "التدمير العبثي للكائنات الجميلة واستغلال الطبيعة لتحقيق مكاسب شخصية". حُوِّلت الرواية إلى فيلم سوفيتي عام 1980.
حصل فاسيلييف على جائزة الدولة السوفيتية لعام 1975، وكان عضوًا في لجنة تحكيم مهرجان برلين السينمائي الدولي التاسع والثلاثين. في عام 1989، انسحب من الحزب الشيوعي السوفيتي، وخاب أمله في البيريسترويكا. في أكتوبر 1993، وقّع على "رسالة الاثنين والأربعين". في أواخر حياته، اتجه فاسيلييف إلى الخيال التاريخي المبني على أحداث من سجلات العصور الوسطى الروسية.
















